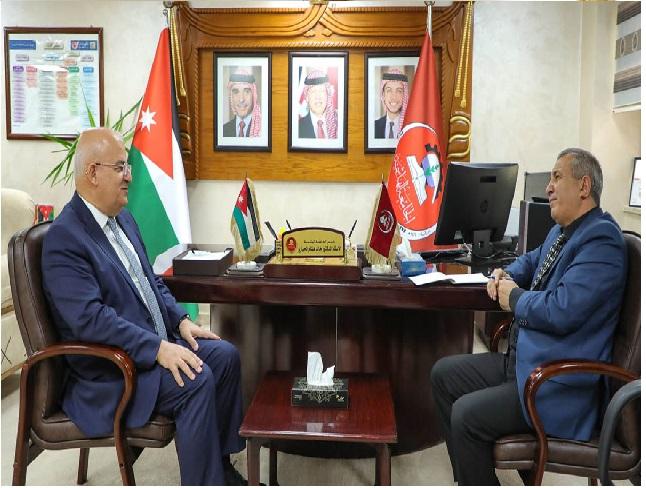شريط الأخبار
 الزميل علي فريحات يوجه رسالة تعهد والتزام للاكاديميين واساتذة الإعلام في الجامعات
الزميل علي فريحات يوجه رسالة تعهد والتزام للاكاديميين واساتذة الإعلام في الجامعات عجلون :جلسة حوارية بعنوان القطاع السياحي بين الواقع والمأمول
عجلون :جلسة حوارية بعنوان القطاع السياحي بين الواقع والمأمول عطوفة محمد التل ابو سعد ثقة وقدها
عطوفة محمد التل ابو سعد ثقة وقدها انتخابات الاتحاد الخيري والنسائي في عجلون(صور)
انتخابات الاتحاد الخيري والنسائي في عجلون(صور) ولي العهد يزور مدينة ام قيس الاثرية
ولي العهد يزور مدينة ام قيس الاثرية الزميل علي فريحات ..الرقم الصعب
الزميل علي فريحات ..الرقم الصعب ابو عنيز تكتب :الزميل علي فريحات صمام الامان
ابو عنيز تكتب :الزميل علي فريحات صمام الامان جمعية البيئة الأردنية تكرّم مراقب الميدان في مجلس الخدمات المشتركة عجلون
جمعية البيئة الأردنية تكرّم مراقب الميدان في مجلس الخدمات المشتركة عجلون في يوم الارض :غزة نموذجا للصمود والتحدي
في يوم الارض :غزة نموذجا للصمود والتحدي

لا مانع من الاقتباس وإعادة النشر شريطة ذكر المصدر وكالة انجاز الإخبارية – الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها فقط