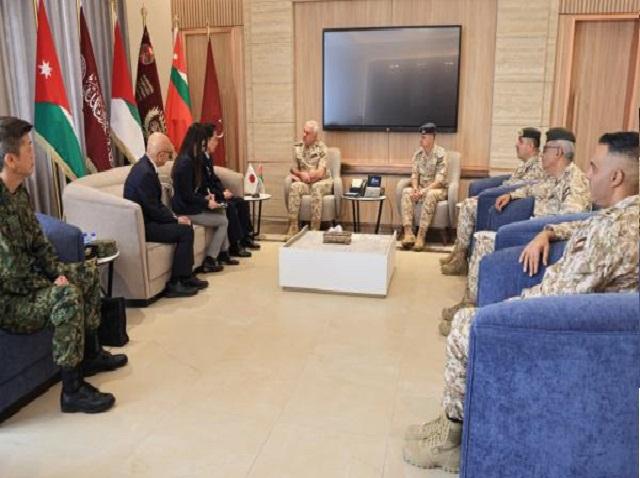النزعة الإحيائية في قصص سناء الشعلان
أ.د عبد المالك أشهبون / المغرب
على سبيل التقديم:
عادة ما ينصب اهتمام المبدعين على موضوع واحد رئيسٍ، فيما تأتي أعمالهم اللاحقة، استئنافاً مكملا، وتنويعاً على الموضوع المهيمن على تفكير المبدع. وربما تبدو هذه الرؤية الفنية متحققة إلى حد كبير في المجموعتين القصصيتين للقاصة الأردنية سناء الشعلان التي جعلت من موضوع الحب، بمختلف تجلياته، وتمظهراته، وتمثلاته، العمود الفقري في مجموع قصصها، واعتبرته منجم الجمال الخالص الذي تغرف منه باستمرار… غير أن أهم ما يستوقفنا في هذا السياق المخصوص، ليس موضوع الحب في حد ذاته، وهو موضوع قديم/حديث، بل الأسلوب الفني المنزاح في تقديم هذه المادة الحكائية، وهنا مكمن الطرافة والتفرد والتميز في الطرح.
وإذا تأملنا هذا الأسلوب بإمعان دقيق، نجده يتحقق من خلال طريقتين أساسيتين هما: إضفاء الحياة على ما أصله جماد من جهة، وبعث شخصيات قصصية من الماضي، و”أسطرتها” من جهة ثانية… وهذا ما أدى إلى تبلور نزعة إحيائية مقصودة وبارزة في مجمل قصصها، عمادها الإسناد المجازي الذي يتم بموجبه إنزال الجماد منزلة الكائن الحي، والشجر والحجر والأشياء منزلة البشر. هذا الأسلوب الفني، أعطى للكاتبة أجنحة لاختراق مجاهل النفس، واستبار أغوارها، وبعث الحياة في موجودات الحياة: أحيائها وأمواتها وجماداتها. فحلقت بشخصياتها بعيداً عن عوالم الواقع الضيق الأفق، مستعيدة بذلك صخب كل ما يعتمل في الحياة سواء ما كان خفياً منه أم منزوياً، ببصيرة نافذة أضافت إلى تكوينات أحداث قصصها أبعادا جديدة لا تخطئها العين…
ومن منطلق هذه الرؤية الفنية المنزاحة عما هو مألوف، جاءت بعض شخصيات قصصها لتأخذ هيئات وأشكالاً وصوراً مختلفة ومفارقة، يتمازج فيها الخارق باليومي، الواقعي بالمتخيل، الأسطوري بالمعاصر… وكل هذه الثنائيات المتقابلة، توفقت القاصة لدى صهرها في نسيج النص القصصي، على وفق وعي جمالي جديد، وهذا الصنيع الفني يشكّل، في رأينا، قيمة جمالية مضافة إلى ما هو موجود.
هذا التصور القصصي، من منظور الكاتبة، يوجَّه ـ بشكل مرسوم ومخطط له ـ في اتجاه تجريب أساليب إبداعية مغايرة، تستهدف ـ في الجوهر ـ إحداث رجات صادمة في مفهوم الكتابة القصصية من جهة، وطبيعة التلقي المألوف من جهة أخرى؛ فمنها ما يمَسُّ يقينيات الكتابة القصصية التقليدية العربية بصفة عامة، ومنها ما يطول خلخلة العلاقة التواصلية مع أنموذج القارئ الذي استمرأ قصص التسلية والترفيه، في الوقت ذاته تشكل مثيرات محمسةً، ومثيرات محفزة للقارئ المتفاعل مع تلك القصص، من خلال دعوته للاحتفاء بها من منظور القراءة العاشقة، والتلقي التفاعلي الخلاق…
1. «أَنْسَنَة» الشخصيات القصصية:
توظف القاصة أسلوب «الأَنْسَنَة» بتقنية عالية، وبكثير من التفنن والدراية والتمكن. ومعلوم أن هذا الأسلوب الأدبي يعمل على تنشيط مخيلة القاص، كما يعمل، كذلك، على توسيع آفاق القارئ على التوقع والتصور والإدراك. فـ«الأَنْسَنَة» ـ من منظور سناء الشعلان ـ مرت عبر تاريخ توظيفها الطويل في الأدب الإنساني بتنوع غاياتها وأسبابها، وتطويعها أدواتٍ وفق الرؤية الفنية والإنسانية والفكرية.
وبخصوص جنوح الكاتبة إلى استثمار وتوظيف الأنسنة؛ فإنّما هو شكل من أشكال تعميم المأزق الإنساني المأزوم، وإشراك الجمادات فيه، وإزاحة المشاعر الإنسانية المحكومة والمرهونة بالتابوات، والرازحة تحت الخوف والقلق والاستلاب إلى الجمادات؛ لتشارك الإنسان بأزمته، وتحمل بعضاً من أعباء حياته، وتقول ما لم يستطع أن يقول، وتندّد بما أجبر على أن يرضخ له مغلوباً مقهوراً. كما إن هذا التوظيف الفني للأنسنة هو من جهة أخرى صورة للاستلاب الذي غدا قانون الحياة اليومية الحاضرة، فكما تستلب الحياة الإنسان المعاصر إرادته وأحلامه وأمانيه، كذلك تسلب الحياة قانون طبيعة الجمادات وصمتها وجمودها, وتدخلها في دائرة الصراع والألم والعذاب.
هكذا يجد القارئ المتفحص لقصص سناء الشعلان، أمثلة كثيرة، تتمظهر فيها ملامح «أَنْسَنَة» الشخصيات… وذلك حينما تعمد إلى بث الروح في ما هو مادي جامد، وتجسيده في مشاهد حية نابضة بالحياة، لكي نلفي أنفسنا أمام جمادات تتحرك وتحس، تنفعل وتتفاعل، تتألم وتفرح، تكره وتحب، مع حرص الكاتبة الدؤوب على أعلى نسبة من التماسك الظاهري في بنية القصة من بدايتها إلى نهايتها…
ففي قصتها “امرأة استثنائية” نجد أنموذج المرأة الموهوبة، القادرة على أن تحرر المأسورين من أسرهم، وأن تبعث الحياة في القلوب الميتة، وأن ترسم الارتعاش على الشفاه الميتة… فبموهبتها الخارقة، تجعل التمثال الصخري الذي يرقد وسط المدينة القديمة منذ سنوات عديدة، يتحول في لحظات إلى شاب وسيم من لحم ودم!… له كل مواصفات العاشق الولهان، واصفة إياه بهذا الوصف الرومانسي البديع: «انحنى التمثال الحي عند قدميها كمن يركع، وتناول جسدها الصغير بين يديه، ودار بها سعادة، وأخذ بتقبيلها»… وبعد لحظات حب استثنائية «عاد الرجل التمثال إلى حياته الصخرية، ودعته بحزن، كانت تعرف طقوس الألم تماماً؛ لأنها اعتادتها، للدقة لم تعتد غيرها، ومن جديد عادت إلى الوحدة»(1)…
بهذا الإجراء الفني، تسعى القاصة إلى عدم تفريغ مضمون القصة من كثافتها التخييلية التي تعد نقطة قوتها بامتياز، بالنظر إلى ما هو مألوف من قصص العشق والغرام في أدبنا العربي، مما يجعل من تلك القصص المنزاحة قابلة للقراءة، وإعادة القراءة، وتجديد التأويل في كثير من الوقائع التي تحتاج إلى طاقة ذهنية مؤولة، أكثر من حاجتها إلى ذات قارئة قراءة محلقة ومستهلكة.
وسيراً على هذا المنوال، تتسع مساحات التشخيص في قصص سناء الشعلان، لتشمل الشجر الذي غدا يمتلك قامة وقداً من جهة، وحركة وحياة من جهة أخرى، وهذا ما تجليه لنا بوضوح قصة “حكاية شجرة” التي عمدت القاصة فيها إلى المزاوجة ـ في أحيان كثيرة ـ بين التشخيص الذي يحاكي أجساما آدمية، وبين التجريد الذي يقوم على توظيف عناصر وأشكال وعلامات ترمز إلى الذكورة والأنوثة… وخلال سرد الوقائع والأحداث يتم الإيحاء إلى مجموعة من الممارسات والعادات والسلوكات البشرية التي تتصف بها الشجرة؛ لأن الأشجار ـ من منظور القاصة ـ مثل البشر، تملك هي الأخرى حكايات وسيرا وملاحم وآمالا وانكسارات، فهي تحافظ على عشقها، وتخلص لمحبوبها مهما كان الثمن…
فلمدة سنين والشجرة المسكينة تعاني من الوحدة والغربة والعقم، إلى أن تحركت بذرتها الأم، واحتضنت شجرة أخرى، لتدفعها من رحمها باتجاه السماء؛ فكان المولود شجرة أنثى. حيث بدت هذه الشجرة طامحة كقارب صغير، أوراقها الصغيرة مثل نجمات في السماء، أغصانها الغضة الرقيقة أحيت القلب الأخضر الذي حصل على شجرته التوأم بفارق زمني جبار. وببزوغ شجرته التوأم إلى الحياة وتبرعمها وترعرعها، نسيت الشجرة الأولى كل شكوكها وتساؤلاتها، وذهبت بمجيئها كل أحزانها…
هكذا تخلَّقَتْ بين الشجرتين حكاية حب قوية، تذكرنا بقصص الحب المأثورة بين بني البشر. فقد كان احتفاء الشجرة/الذكر بوجود شريك لها، احتفاء ما له مثيل، بحيث ينزاح بأغصانه يسرة أو يمنة ليسمح للنسيم بمداعبة أوراق شريكته ووليفته، ينحني على قمتها، فيطوقها بأغصانه كما يطوق العاشق الولهان حبيبته؛ ليمنع أشعة الشمس من إذبال أوراقها… هكذا يستيقظ مع الجسد الواحد جسد آخر مشترك، يتناسل من صلبه، وتصحو معه الرقة والنعومة والإحساس بالآخر الشريك…
وككل نهايات قصص العشق والغرام؛ كانت نهاية قصة الشجرة التوأم مأساوية بكل المقاييس. فشكلهما الشاذ دون أشجار الغابة، أغرى النجار ببترهما بمنشاره الكهربائي، فصلهما دون رحمة عن الجذع، فهويا على الأرض.
وفي اعتقادنا الشخصي، إن هذا التصور لقضية الخلق في العالم النباتي، من منظور سناء الشعلان، ليست له دلالة مجازية فحسب، بل هو هوية جوهرية في العديد من قصصها. ذلك أن القاصة تفتح هذه الرؤية من تصورين أساسين، تحيل عليهما بطريقة غير مباشرة:
ـ التصور السائد قبل الإسلام: كان الاعتقاد السائد قبل الإسلام أن المرأة «خُلقت من بعض أعضاء الرجل. فقد خلقت الشجرة/الأنثى من جذع الشجرة/الذكر بعد طول انتظار. وكما ورد في الإصحاح الثاني من سفر التكوين في العهد القديم: “فأوقع الربُّ سباتاً على آدم فنام. فأخذ واحدة من أضلاعه وملأ مكانها لحماً. وبنى الرب الإلهُ الضلع التي أخذها من آدم امرأة وأحضرها إلى آدم”»(2).
ـ التصور البدائي لرؤية الإنسان إلى المحيط حوله: وهنا تذكرنا هذه الشجرة «المُؤَنْسَنة» بقصة الشيخ المسن الذي انتفض في وجه الدركي، والذي جاء يبحث عن طفل كي يجبره على القيام ببعض الأعمال الصعبة، كان يفرضها البيض على سكان القبائل قائلاً: «أنظر لهذا الذراع، إنها من الماء». فالطفل في ظل هذا التصور البدائي يكون شبيها ببرعم الشجرة؛ يكون مائيا في البداية ثم يخشوشب، ويصبح صلبا مع الزمن»(3).
ففي بعض الحضارات، تستخدم اللفظة الدالة على جسم الإنسان كي تشير إلى كل ما هو مادي ومعنوي، معقول ولامعقول، مرئي وخفي، عليه يغدو الحجر والشجر، وهنا لا يصبح للجسد نهاية. فلا حدود بين عوالم الأحياء والأموات؛ إذ إن الجسد لا ينتهي والمادة لا تفنى ولا تستحدث حتى قبل أن يقول العلم بها بطريقته الخاصة، والموت ليس شكلا للعدم بل حالة التحول والوجود الآخر، والمتوفى يمكن أن يحل في حيوان أو شجرة أو قطرة ماء أو إنسان آخر، ويمكن أن يعود إلى القرية أو المدينة بعد موته ويختلط بالأحياء والإنسان، لا يوجد من خلال حياته إلا من خلال علاقاته بالآخرين، وهو يستمد عمقه وقوته وقوامه من مجموع صلاته بالآخرين.
فالكاتبة هنا تجد أكثر من مبرر لإدراكها الفني هذا، وذلك من خلال بعث الحياة في الشجرة، تماماً كما يستشعر الفلاح روح تلك الشجرة الحية في بذرة دفنها تحت التربة، لينتظر بعد ذلك لحظات الإخصاب والانفلاق، والتبرعم.
ولقد تسلل أسلوب «الأنسنة» عند القاصة إلى باقي قصصها، ليطول هذه المرة الأدوات والأشياء التي يستعملها الإنسان في حياته الخاصة والعامة… وهذا ما تفصح عنه قصة: “الفزاعة” التي صنعتها فتاة المزرعة من ملابس رثة، وقبعة قديمة، بقدمين خشبيتين، وجسده مصلوب؛ صنعته منذ أشهر طويلة وزرعته في هذا المكان من حقل الفراولة كي يفزع الطيور، ويمنعها من مداهمة الحقل وأكل الثمار، فإذا بهذا الكائن الخشبي يبدي الكثير من الرقة والعواطف الجياشة تجاه من صنعته.
ومن الجلي، أن قوة الأسلوب القصصي هنا تكمن في أن لا تكون تلك الفزاعة جماداً فحسب، بل موجودا من الموجودات المنغمسة في انتمائها إلى عالم الطبيعة الحية لا الميتة كما يعتقد عامة الناس. حيث يتم تركيب هذه القصة العجيبة في حبكة حكائية لها بداية كما لها نهاية؛ تبتديء بصنع الفتاة الفلاحة فزاعة لإخافة الطيور من العبث بمحصول الفراولة الحمراء كعادة الفلاحين في كل بقاع المعمور. إلا أن المفارق للواقع، هو أن تبعث الحياة في الفزاعة لتتحول إلى ما يشبه كائنا بشريا، لا يخفي مظاهر إعجابه بالفتاة الفلاحة، إلى درجة الوقوع في شرك حبها إلى حد الوله. فكلما اقتربت الفلاحة من الفزاعة أبدت هذه الأخيرة الكثير من مظاهر الفرح والانبساط، وكلما نأت عنها ازداد شوقها لرؤيتها، أما إذا بكت الفتاة لمكروه أصابها، فذلك يولد لدى الفزاعة الكثير من الكآبة والحزن الشديدين، تعاطفا معها…
هكذا كان حال الفزاعة إلى حين حلول ضيف عزيز على فتاة في المزرعة. وهنا وقع المنعطف الكبير في قصة وسيرة هذا الحب الغريب والعجيب، حتى وإن كان حباً من طرف واحد… فبترقب شديد، وبانتظار ملؤه الغيرة الحرَّى، راحت الفزاعة تراقب أجواء علاقة الفتاة مع ضيفها الغريب، وهما يقضيان أمسية رومانسية جميلة هادئة… لكن الذي لم يفهم في نهاية هذا اللقاء، هو التغير الذي حدث بعد ذلك. حيث تعالى صراخهما، وبدا أن ناراً تشتعل بينهما، ثم غادر الضيف المكان غاضباً، وصك الباب بقوة كادت أن تخلعه، وارتمت حبيبته على أريكة قريبة من الباب، وأجهشت في البكاء…
وسط هذه الأجواء الملتبسة والملتهبة، قدّرت الفزاعة أن الفلاحة حزينة جدا، وفي الحاجة إلى قلب يحبها بشدة، لقلبه مثلاً، «كاد أن يناديها من مكانه ليسألها عن سبب حزنها، ولكنه تذكر انه لا يعرف اسمها، فهو لم يسمع أحداً يناديها باسمها من قبل، فكر قليلاً، ثم استجاب إلى وجيب قلبه، ترجل عن مكانه، وقطع الحقل الصغير، داس دون أن يقصد بعض حبات الفرولة الحمراء، لم يقرع الباب، فتحه دون انتظار، ودخل إلى الكوخ… » (4).
وعلى إيقاع هذه الوقائع الميلودرامية، تنتهي القصة نهاية مفتوحة، لا علاقة لها بالنهايات الغرامية المألوفة في قصص العشاق والمغرمين؛ نهاية تفتح أكثر من أفق انتظار، وتحفز على أكثر من تأويل عن مصير علاقة عجيبة وغريبة، بين فزاعة/ جماد وفتاة المزرعة من لحم ودم وشعور…
وعلى غرار القصص السابقة، تمتد تقنية “الأنسنة” هذه لتشمل حتى اللباس (البنطال) الذي عادة ما يوصف بأنه الجلد الثاني للإنسان. فمن خلال عنوان القصة: “الجسد”، تركز القاصة اهتمامها هذه المرة حول موضوع «الجسد» في امتدادته الوجدانية والعاطفية، بكل ما يحمله هذا الجسد الموصوف من دلالات وتأويلات لا نهاية لها.
وإن كان جسد الإنسان هو مكان الانطلاقة الأولى للأمل والحياة والتفاؤل والتمكن والسيطرة والتقدم والمجاوزة والانتصار على كل مظاهر النقص والقصور، وإن كان، كذلك، مكان الانفعالات والأحلام والغرائز، وحالات الفرح والحزن والشيخوخة والموت؛ فإنه ـ لا محالة ـ سيغدو مع مر الوقت «مكان الخيال والتفكير والمنطق والتصورات والإبداع والفرح النهائي بالآخر الذي انفصل عنه والذي يحن إليه دائماً»(5).
وهذا ما دفع المجتمعات عامة، والمجتمع الاستهلاكي الغربي خاصة إلى إيلاء أهمية قصوى لفنون صناعة الجسد. إذ أصبح الحديث عن صناعة النجوم في السينما والمسرح والرياضة والغناء والموسيقى والتلفيزيون والحياة السياسية بشكل عام، إحدى الهموم الأساسية للإنسان المعاصر، وفي كل هذه الحالات، هناك تأكيد خاص على جماليات الجسد الجميل القوي المكتمل الخاص، ولو أنه ذلك الجسد الافتراضي البعيد والمنعزل والمنفصل الذي ينظر إليه الرائي من بعيد.
غير أن نماذج الأجساد الموصوفة في قصة سناء الشعلان لا تشبه أجساد النجوم والمسرح والرياضة… إنها أجساد ملقاة على أرصفة العرض المزدراة: «أجساد متناثرة عليها بلا نظام، أجساد ملونة، أجساد موشومة، أجساد مشعوعرة، أخرى حلساء، أجساد بكل الأحجام (…)، وبعضها معيب بحرق، أو كسر أو خلع؛ لذا يعلن عن تخفيضات إضافية عليه»(6). إنها في النهاية، أجساد متعرقة، تكاد تتقدد من الحر، لا تغري أبدا الناظر بالنظر إليها، بقدر ما تثير الشفقة…
وعنصر المجاز هنا صريح وواضح، فالبنطال الأثير لدى صاحبه يحمل العديد من الذكريات. فهو بنطال خاض معارك غرامية واحدة تلو الأخرى، وعاد مهزوما المرة إثر المرة، ورضي كما يقولون بالإياب غنيمة، ومع ذلك ظل عاشقا للغة الأجساد التي أرهقته وأضنته، وما استطاع للغزها فكاً، ولا لعمقها سبراً، «فمنذ أن أحب [البنطال] ذلك الجسد الذي هجره شعر بأن جنباته قد تفتقت، وأن لونه قد أصبح كالحاً، أزراره تدلت، ولم تعد مشدودة موثقة في مكانها كما كانت، عروته العليا اهترأت، وخصره بات متهدلاً مرتخياً، ونسي تماماً الشموخ، وبات يعيش على ذكرى ذلك الخصر الأهيف الذي طالما خاصره بكبرياء وإثارة»(7).
إنه بنطال آثر أن يعيش على ذكرى الجسد الذي أحبه، يومها أقسم على أنه لن يعشق أي جسد، ولن يعطف على أي عار، وسيحبس نفسه وفضوله على نفسه ولا غير، ولكن روحه تتوسل إليه في سبيل الحصول على جسد، تبحث عن وعاء يحتويها، وهنا تتجلى أبرز مظاهر الصراع الداخلي الذي يعيشه البنطال بين مقاومة الجانب الجنسي المنحط فيه وبين تثبيت وترسيخ البعد الرومانسي المتعالي.
والملفت للنظر في هذه القصة، هو أن سناء الشعلان ستعمد إلى تصوير البنطال في أوضاع قريبة جدا من أوضاع الإنسان العاشق. فهو بنطال يحدث نفسه، يتذكر الزمن الجميل، يئن تحت وطأة مواجع الحاضر، يتقلب شوقا إلى الجسد المشتهى، ويحن إلى الغائب الذي هجر. هكذا نلفي أنفسنا أمام بنطال يمتلك إحساساً عارماً، ورؤية جمالية، ولمسات فنية تميزه، حتى لنخاله كائنا إنسانيا حياً: يشعر ويحس، ويتمنى ويقارن…
ومن أنسنة الحجر إلى أنسنة الشجر، ومنها إلى أنسنة الأدوات)”الفزاعة”(، وهذه المرة ستبث الكاتبة الروح في”المانكان”. ففي قصة)”عالم البلورات الزجاجية”(الطريفة، تحكي القاصة سيرة شخصية عطا التي أُجهِضت كل أحلامه وآماله في أن يدخل كلية الطب، نظرا لحالة الفقر والبؤس والفاقة التي يعيشها، وعوضا من أن يكون طبيبا أصبح فتى الفرن الذي ينقل الخبز إلى عالم وبيوت الأغنياء على دراجته الهوائية…
يصادف عطا موعد افتتاح متجر فخم في حي الأغنياء، ويبهر عطا بالمرأة البلاستيكية أيما انبهار. وبما أنه كان جد مهووس بالبلورات الزجاجية، فقد وجد ضالته في تلك المرأة التي يتأملها خلف الزجاج بكثير من العشق الخفي الملتاع. تتوطد بينهما عرى المحبة، ويتواصلان عن بعد بلغة العيون، ويتوق كل واحد منهما إلى معانقة الآخر، ليظل السؤال/الإشكال هو كالتالي: من منهما سيغادر عالمه ليلتحق بالآخر؟ وبما أن عطا كان أشد حماسة وانجذابا إلى المرأة البلاستيكية، فقد كان أكثر اندفاعا وجرأة وتهوراً. فلم يكن من سبيل أمام عطا، للارتماء في أحضان عشيقته، إلا اختراق واجهة المتجر الزجاجية في موقف بطولي مأساوي مجنون، يلقى بعدها عطا مصرعه من جراء هذا الفعل الجنوني الذي أقدم عليه، ليغدو موته حدثا مؤسفا لدى كل من عرف قصة حبه الغريبة والعجيبة مع المرأة البلاستيكية.
كما إن قصة “زاجر المطر”، تتماهى إلى حد كبير مع قصة عطا في “الكابوس”… إذ تنتخب القاصة شخصية عجيبة، كذلك، وسمتها بـ”زاجر المطر”. فقد اعتاد هذا الشخص أن يراقب المانكان على باب المتجر كلما مر أمامها صباحا أو مساء في نوبات عمله… يركن الرجل دراجته بالقرب من المتجر ثم يجلس في مقعد خشبي مواجها تماما للواجهة التي تنتصب فيها المرأة البلاستيكية محدقة في البعيد… يحدثها عن كل شيء: عن فقره وعجزه وموهبته الخارقة في زجر الأمطار، وتحدثه من جهتها عن عالمها البلاستيكي، تسر له بأحلامها وأمنياتها؛ فتحنو عليه، يتمناها فتحلم به، يحبه ويحبها… وأمنياتهما في تنفيذ قرار زواجهما مهما كان الثمن. فقد كان العاشق الولهان يرسل إلى حبيبته باقة زهور، لكن عمال المتجر يرفضون إيصالها إليها، ويتهمونه بالخبل والجنون، «فأنى لرجل أن يعشق امرأة تمثالا؟ !»(8)..
ومن المظاهر البارزة لحضور النزعة الإحيائية في هذا النص القصصي، حين تتحرك المرأة التمثال، وتخطو إلى الأمام، إذ ألصقت فمها بالواجهة الزجاجية، وطبعت للرجل العاشق قبلة على الحائط الزجاجي الذي يفصلهما… وتواعدا على أن يتزوجا، وأن يهبها مهرا لم تحصل عليه امرأة من قبل، سيهديها مطراً سيهطل مدراراً…
في المساء، كانت المدينة غارقة في أمطار غير متوقعة اجتاحتها في غير موسمها، وأفسدت كل شيء، ومنعت الجميع إلا قلة من حضور جنازة زاجر المطر الذي مات إثر حالة جنون مفاجئة، دفعته على وفق تقرير الطبيب الشرعي إلى اختراق جدار زجاج المتجر، كما كان حال عطا في نهاية قصة “عالم البلورات الزجاجية”.
وفي قصتها المشوقة: “آنسة قطة”، تتابع القاصة مشروعها الفني، وذلك من خلال اختلاق مواقف طريفة تجد شخصيات القصة نفسها فيها. فقد تعودت الموظفة)بطلة القصة(كل مساء، مشاهدة مسلسلها التليفزيوني المفضل الذي اعتادت أن تشاهده منذ أن كانت طفلة، لكن منذ أن كبرت، ومنذ أن توقف عرض حلقات مسلسلها، عمدت إلى شراء حلقاته الكرتونية كاملة، واعتادت أن تشاهدها حلقة إثر حلقة، حتى أصبحت تحفظ حلقات المسلسل الكرتوني عن ظهر قلب…
فقد دأبت أن تتابع بطل مسلسلها الوسيم الشهم الذي يشق أيام حياته، ويضني نفسه في مساعدة الآخرين، وفي ملاحقة الشرير الذي خطف حبيبته التي لم تعرض صورتها ولو مرة واحدة في كل حلقات المسلسل؛ والذي كان ينتهي دائما نهاية مأساوية تفطر قلبها. فبطلها الوسيم ينتهي صريعا أمام البرج الذي تسكنه حبيبته دون أن يراها، لتستغرق في بكائية حزينة اعتادتها، وكادت تدمنها.
كبرت هذه الفتاة/الموظفة، وتحققت معظم أحلامها إلا الحب، فقد كانت تعسة متعثرة فيه، فكلما أحبت رجلا زهد بها، ولم يحبها، وكلما أحبها رجل زهدت به ولم تحبه، وبذلك عرفت الحب العديد من المرات، ولم تجد الحبيب، وبقيت تحلم بالفتى الذي يتقن فنون الحب والفروسية.
في هذه الليلة الاستثنائية، ستشاهد المرأة الحلقة الأخيرة من مسلسلها المفضل. كم تشعر بالتوتر من النهاية المأساوية لبطلها الوسيم والشهم. لكن بطل حلقاتها الكرتونية هذه المرة «مزيج من رجل وسيم وقط أشهل، له وجه وقامة رجل، وعينا وأذنا قط، وذيل مشعوعر كثيف يطوح في الهواء»(9)…
وهنا يتدخل خيال القاصة التي ستشخص بطل مسلسلها الكرتوني “نيمو الشجاع”، وهو يخوض علاقة غرامية مع المرأة المعجبة به حد الوله، يُجْرح نيمو الشجاع، وتتصور الموظفة المسكينة نفسها تلعق جرحه ويبرأ، ويتخلص بطل مسلسلها من براثن تلك النهاية المأساوية التي كانت تنتظره لولا تدخلها في أطوار المسلسل، وتخيلها قصة موازية على هامش القصة الأصل، وهنا يخاطبها قائلاً: «أنت من وهبتني الحياة من جديد… أنت قوتي السحرية»، وتجيبه «وأنا أحبك… أحبك.. احبك… »…
هكذا ينتهي شريط الفيديو، إذ يبتلع السواد البطل، وتختفي كل الألوان، وتشعر الموظفة أنها تهوي من عل في سديم أسود، ثم تستيقظ في حالة هلع قصوى، بعد أن تحطمت كل أحلامها على صخرة الواقع الممانع لكل رغباتها الدفينة في الحب والعشق والغرام…
تفضي بنا هذه المعطيات النصية السابقة، إلى أن الرؤية التشخيصية والتجسيدية في قصص سناء الشعلان(10) امتزجت بالبعد الفلسفي الذي حضر جنباً إلى جنب مع البعد الجمالي أو الفني، وهذا ما جعل القاصة، بحق، تخلق لنا عشاقا من عينة مفارقة للواقع: التمثال العاشق، أو امرأة العرض البلاستيكية(المانكان)، أو الفزاعة العاشقة، البطل الكارتوني… كل هذه الشخصيات المتخيلة والمختلقة غدت تنطق بعبارات الجمال في رشاقة واتزان، برؤية فكرية ناضجة تنم عن المحمول الثقافي الذي تختزله بين طياتها، وفي سياق قصصي تغلب عليه عناصر التخييل المفارقة للواقع.
فعلى الرغم من طبيعة تلك الشخصيات الجامدة، غير أن خيال القاصة الجامح ساعدها على خلق علاقات شبه إنسانية ما بين هذه الخامات الصعبة التطويع، فطوعتها وطاوعتها، وسلمت لها مكامن القوة والضعف، الجمال والبشاعة، الحب والكره، وهذا هو الرهان الفني الصعب الذي راهنت القاصة على تحقيقه وهي تستثمر هذا الأسلوب الفني المتميز.
وهذا ما تؤكده القاصة حين تصرح، في معرض حديثها عن رهانات هذا الأسلوب القصصي من منظورها، قائلة: «أنا أراهن على استفزاز الإدراكات، والتنديد بصمتها من وراء هذا التوظيف، الذي يعير الجمادات مواقفنا وأحاسيسنا وغضبنا الإنساني، ويسمح لها بالتعبير عنها بكلّ صراحة وصدق يجرح صمتنا المتخاذل، ويعرّي استلابنا، وهو من جهة أخرى كذلك يلعب على تقنية فنية مفتوحة على الكثير من السرديات التي تجنح إلى التعمية والإبهام والإلغاز، وتتخطّى ضوابط الأبعاد الزمنية والمكانية المحكومة لقوانين الطبيعة الفيزيائية. وإخال أنّني في بحثي عن طريقة وأداة للتنديد بالصمت والاستلاب والتواري خوفاً من التابوات والهروب من المساءلة قد وقعت في شرك الاستلاب كذلك».
2 ـ “أسْطَرَةُ” الشخصيات القصصية:
رغبة منها في تأصيل تجربتها القصصية عن طريق استلهام أنموذج حكايات “ألف ليلة وليلة”، وحرصا منها، كذلك، على امتلاك قارئ مفترض، منتسب وجدانيا إلى عوالم ومخزون الحكاية الشعبية، عمدت سناء الشعلان إلى إضفاء الطابع الأسطوري على بعض شخصياتها القصصية…
فالقارئ العربي ـ كما نعلم جميعاـ شديد الإعجاب بقصص الخوارق التي ما فتئت تذكرنا بمخلوقات عجيبة، تغدي ذاكرتنا الشعبية منذ آلاف السنين، وتفجر خيال القصاصين في هذا الميدان إلى يومنا هذا، حيث ترسخ استثمار عوالم الجن والعفاريت، وتوظيف قصص السحر ومفعولاته على المسحور…
على هذا المنوال، تبدو قصة “الرصد” مستوحاة من حكايات ألف ليلة وليلة. وتحكي قصة الساحر اليهودي الذي قدم من آخر تخوم البحر هدفه رجل واحد هو عزوز، وجد اسمه وزمنه مكتوبين في كتاب السحر الأكبر. فقد ذكره اليهودي بأن على يديه سيفك الرصد المضروب على الكنز، وكانت المعادلة واضحة بين الطرفين: سيقرأ اليهودي طلاسمه، أما عزوز فعليه أن يلزم الصمت، وأن لا يتفوه بكلمة، لأنه إن تفوه بكلمة سيهلك الاثنان معاً، وسيغلق الكهف على الرصد لألف سنة أخرى…. وفي حال ما إذا وصلا إلى الكنز سيتقاسمانه؛ فيعود الأول إلى موطنه في آخر الدنيا، ويرى الثاني بعينه اليتيمة ما لم يره رجل من قبل بعينيه الاثنتين من غنى وجاه.
وحينما وصلا أخيرا إلى عين المكان، بدأ اليهودي بترديد طلاسمه السحرية، فكانت ترانيمه باعثة للجنية الأفعى التي بدا وكأنها تستيقظ من سباتها الطويل… وفي لحظات، تفتق جلدها عن فتاة بجمال أردية القمر. انبهر عزوز لمارآها، كانت فتاة تستدعي بجمالها سنوات حرمانه، رأى في عينيها اشتهاء له لم تر عينه اليتيمة مثله طوال حياته، فعيون الجميلات ـ حسب تصوره البسيط ـ لا تلمح الرجال البسطاء الفقراء…
كانت الفتاة الجنية متدثرة بملابس شفافة، سرعان ما أخذت تلك الملابس تتطاير مع كل ترنيمة من ترنيمات اليهودي. كان في عينيها، كذلك، خوف ورعب وهي تصرخ: ” يا عم استر علي، الله يستر عليك، يا عم كلماتك تعريني من ملابسي، استر علي الله يستر عليك”. لم يلتفت اليهودي إلى صراخها
لأنه مدرك أشد الإدراك لخطورة ما سيحصل، أما عزوز فكان يحترق شوقاً لإنقاذ الجنية التي بدأت بالتوسل إليه قائلة: “انقدني يا عزوز، استر علي الله يستر عليك”، ومع ذلك صم عزوز أذنيه عن رجاءاتها ودموعها، حتى قالت له الجنية الأفعى: «عزوز أنا احبك، أنتظرك منذ ألف عام، أستر علي الله يستر عليك»…
لقد أفلحت الأفعى الجنية في إيجاد الكلمة ـ المفتاح لشخصية عزوز؛ إنها كلمة الحب التي كان وقع ترديدها برقة وحنان فوق ما تتحمله شخصيته المتعطشة دوما إلى هذه الكلمة، فلأول مرة يسمع امرأة تقول له أحبك. طوال تاريخ حياته المجيدة لم تحن عليه امرأة؟ وأي امرأة؟ امرأة الرصد. وفي هذا المقام الوجداني الملتهب، سينفجر عزوز في وجه اليهودي بانفعال: “كفاك… استر عليها أنا أحبها”؛ وفي لحظات كان اليهودي رمادا منثورا…
هكذا، نجا عزوز في اللحظات الأخيرة، وهو يستجيب لوجيب قلبه الخافق بنبض الوجد والعشق، وكادت لعنة الرصد تحيله إلى رماد كما وقع لليهودي، «لكن الجنية الأفعى عشقت في عين عزوز شيئاً لم تره من قبل في عين إنسي، مدت يدها العاجية إليه، واختطفته بعيداً حيث مملكة الجان، ومن جديد أقفل باب الكهف على الرصد»(11). أحبته الجنية الأفعى، وحملته معها إلى عوالم أخرى غير بشرية، فيما عاقبت اليهودي المهووس بالمال، بأن حولته رماداً منثوراً…
وفي هذا السياق القصصي المتسم بالغرابة والعجب، تنتقل بنا القاصة، في كشكولها القصصي هذا، لموضوع طريف ومألوف: إنه موضوع حب الجن للإنس والإنس للجن. فقد كان هذا النوع من الحكايات مصدر إغراء كبير في التراث الحكائي عند العرب وما يزال. وما لا شك فيه، كذلك، هو أن الجن في الثقافة العربية، كما تورد ذلك سهير القلماوي، «غير قادرة على الشر الكثير، وهي غالبا خيرة وعلاقتها بالإنسان حسنة، تكن عرفاناً بالجميل أحياناً، وحباً حينا آخر»(12).
ففي قصة “قطته العاشقة”، تروي الكاتبة حكاية الرجل الذي كان يربي في بيته قطة أليفة. سيتعرف الرجل لاحقاً على إحدى الفتيات، وسيقرر أن يتزوجها. فكان أول قرار لهذه الزوجة المنتظرة هو أن يتخلص زوجها من تلك القطة التي كان يربيها، ذلك ما فعل الرجل على مضض، وعلى كره منه… ويوم زفافه، ستتسلل قطته إلى غرفته بطريقة مفاجئة، «حاولت أن أداعبها، لكنني شعرت بنفور منها لم آلفه، حضنتها رغما عنها بين يدي، في عينيها رأيت دموعاً، وفجأة انهمرت دموعها، اختلطت الأمور علي، أنّى لقطة أن تبكي مثل البشر؟ ! كانت تلك الدموع بوابتها إلى البشرية، فقد انسلخ جسدها، وتفتق عن فتاة رائعة، قبلتني، وضمتني بشدة، كان منظرا مروعا لي، فقد حسبتها شيطاناً أو روحا شريرة، وهربت صارخا خارج البيت… » (13).
وكان الزفاف بكل طقوسه المعروفة. وطوال أيام الخلوة مع زوجته لم يفارق طيفها الآدمي ناظره. إنها بالفعل امرأته الخرافية التي أفنى عمره في انتظارها.. ولما عاد إلى البيت، وجد قطته ميتة ومتعفنة. ترتب عن هذا الفعل الشنيع، هجر الرجل زوجته وهجر البلدة، للتفرغ بعد ذلك لتربية مئات القطط فيما بعد. وطوال السنوات انتظر أن تبعث روح قطته الأثيرة في إحدى تلك القطط بدون جدوى، وتمنى أن يجدها لكي يقول لها كم هو هائم بحبها، ويخبرها بمدى عشقه لها…
ولعل من أهم مواصفات الشخصيات الخارقة والعجيبة، أنها مرئية وغير ومرئية في الآن ذاته، إنسية وجنية، وهذا ما يمكنها من أن تخرج وقتما يكون الإنسان في غنى عن ظهورها، وتظهر دائما فترتبك أحوال البطل من جراء هذا الظهور غير المرتقب. فهي قد تشق الحائط فتخيف، أو تكون حيوانا متنكرا مسحوراً فتصل إلى أغراضها؛ لأن الجنية لا ترضى عن زواج حبيبها الإنسي، وتريد أن يكون لها وحدها… كما إن مما هو معروف، أن الإنسي في التراث العربي القديم لا يحترم الجنية إلا إذا كانت محبة له، ورحيمة به…
ومن قصة تحول القطة إلى جنية، تعرج بنا القاصة على موضوع تحول الشخصية الحيوانية إلى شخصية إنسانية في قصتها الغريبة والعجيبة: “المستأنس”. فبالعودة إلى تاريخ الآداب العالمية، نجد أن بعض النصوص القديمة عمد أصحابها إلى استثمار عنصر الغرابة من خلال ثيمة «التحول» (أو كما يسميها بعضهم الآخر«المسخ»). ونستحضر في هذا المقام بالضبط نص: “حياة لاثاريو ديي تورميس”(مؤلفها مجهول)، ويعود إلى حوالي 1554. فضلاً عن “تحولات الجحش الذهبي””L’âne D’or ou les métamorphoses ” للوكيوس أبوليوس Apuleé (القرن الثاني للميلاد).
أما في العصر الحديث، فإن ظاهرة التحول تبلورت بشكل جلي في لوحات السورياليين، وتيار العبث واللامعقول. كما مثلت أعمال فرانز كافكا أنموذجاً رائداً في هذا المضمار الأدبي، ولاسيما في روايته المشهورة: “المسخ” ” La Métamorphose “. وسيستوحي كتاب مسرح العبث واللامعقول في أوربا، كذلك، ما يشبه ذلك الانشغال الحثيث في إبداعاتهم. هكذا سيصف لنا أوجين يونسكو (Eugéne Ionesco) في مسرحيته الشهيرة: “الخرتيت” “”Rhinocéros(1985)، خروج جون(Jean) من الحمام وهو يصدر أصواتا حيوانية مرعبة، وفجأة يندفع خارج الحمام كما الخرتيت صوب صاحبه الذي يضطر إلى التنحي جانباً ليتفادى أن يدهسه صديقه/الخرتيت.
ولإن كان هؤلاء الكتاب ينطلقون من فكرة تحول الكائن الإنساني إلى حيوان، فإن سناء الشعلان قلبت المعادلة، وهذا ما نجده في قصتها: “المستأنس” التي تحكي عن ذئب يتحول في كل ليلة اكتمال البدر إلى إنسان طيب، يحسن إلى كل الناس، ويخفق قلبه بالحب الطاهر، ويحيط كل معارفه بالرعاية. حيث تستمر دورة التحول على مستوى الكائن ابتداء من الشكل الخارجي إلى أن يذوب الشكل الأول(الحيوان) ويحل محله الشكل الثاني(الإنسان)…
وبالرجوع إلى ماضي هذه الشخصية الغريبة الأطوار، تذكرنا القاصة أن هذا الذئب كان قد أصيب من قبل بمرض حمى المستأنس المزمن الذي لم ينفع معه علاج؛ لأنه يقر في قرارة نفسه أنه يعد المستأنس أسطورة لا مكان لها في حياة الذئاب. غير أنه في بعض الحالات تنتابه لحظات استيقاظ الضمير، وترتفع لديه درجة التعاطف، وتتأزم مشاعره يشعر بأن فروه في تناقص واضح، وتقل لديه النزوع إلى الدم والقتل، ويميل إلى مساعدة الآخرين، ويدق قلبه بالحب… لكن لؤم الذئاب يتدخل ـ ولحسن الحظ ـ في الوقت المناسب، ليستعيد هذا الإنسان الذئبي كامل صحته، ووافر «ذئبيته» بمجرد اقترافه لخطيئة ما أو التستر على مذبحة مثيرة…
هكذا، تسرد علينا القاصة سيرة حياة هذا الذئب المريض، بأنه قد أقام قبل ذلك في مصحة راقية سرية في بلد ما، يعالج من مرضه الفظيع هذا، الذي كان إذا أصابته نوباته تحول إلى إنسان بطباع دمثة، وروح طيبة، وقلب يخفق بحب البشر، ولكنه سرعان ما يشفى من مرضه، وإن بقي عرضة للانفصام في أية لحظة.. مع أنه يعلم علم اليقين«أن ذئبيته سوف تنتصر دون شك على انفصام المستأنسين الذي يهدد حياته، ويروع أمن مجتمع الذئاب… »(14).
إنها قصة عجيبة وغريبة كذلك؛ قصة كائن حيواني مصاب بمرض الانفصام، متعطش دوما إلى الدم على طريقة مصاصي الدماء. فحين تنتابه حالة التحول إلى إنسان لا يستطيع أن يقاوم نزوع الحيوان في أعماقه طويلا، إذ سرعان ما يتخلص من حالته الإنسانية ليتحول حيوانا شرسا لا يرحم. وشواهد وحشيته، وفظاعة سلوكياته كثيرة ومتعددة. فقد نهش لحم جاره السمين، وذبح أخاه، وفتك بأمه، وفي الأخير أطلق النار بمسدسه على حبيبته، وكانت الطلقة الأخيرة باتجاه رأسه محاولة منه للخلاص من هذا المرض الذي يقض مضجعه، ويحول دون ممارسته حياته الحيوانية المعتادة…
وإجمالاً، يمكن للقاريء المتفحص أن يستشف من تجربة سناء الشعلان القصصية أنها تختزل جوانب غنية وثرية وعارمة من هوية الثقافة العربية والإسلامية بله الإنسانية، إذ تزاوج بين الثابت المتمثل في الوعي بأهمية التصحر العاطفي في حياتنا العربية من جهة، والمتحول الذي ينهض على أسلوب تقديم هذا الموضوع القديم/الجديد من منظور رؤية فنية ملؤها التجسيد والتشخيص من جهة أخرى، وذلك في أفق تجاوز طرائق المعالجة القصصية التقليدية لهذا الموضوع. وبهذا التصور الفني المتميز، تعيدنا الكاتبة إلى التعريف السهل والممتنع لكتابة القصة: إنها تلك الرؤية الفنية الخلاقة التي تحول كل ما تراه العين، وما تستشعره الأحاسيس، وما يعلق بالمخيلة، إلى موضوع جديد للكتابة القصصية، وهنا تتجسد فكرة الإبداع القصصي، بكل ما للكلمة من معنى.
هوامش البحث:
1.سناء الشعلان: “قافلة العطش”(مجموعة قصصية)، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، الأردن، ط: 1، 2006، ص: 53.
2.علي القاسمي: “مفاهيم العقل العربي” دار الثقافة، الدار البيضاء، ط: 1، 2004، ص: 120.
3.شاكر عبد الحميد: “أنثربولوجيا الجسد والحداثة”، مجلة: “إبداع”(مصر)، العدد التاسع، سبتمبر 1997، ص: 91.
4.سناء الشعلان: “قافلة العطش”، مرجع سابق، ص: 30.
5.شاكر عبد الحميد: “أنثربولوجيا الجسد والحداثة”، مرجع سابق، ص: 98.
6.سناء الشعلان: “قافلة العطش”، مرجع سابق، ص: 123
7.المرجع نفسه، ص: 121
8.المرجع نفسه، ص: 115.
9.سناء الشعلان: “الكابوس” دائرة الثقافة والإعلام، حكومة الشارقة، 2006، ص: 128.
10.من القصص الأخرى التي يتم فيها استثمار تقنية البعث والإحياء بشكل ملفت للنظر، نجد قصة قصة: “القاتل” التي تحكي عن شخص يحارب ظله الذي لا يفارقه، والذي يمنعه عادة من ارتكاب المعاصي والآثام… وأخيراً مات ظله، بل قتل ظله. هو من قتله، كان موته حزينا، وكلنه عاد وعزى نفسه قائلا: «ولكن موته كان ضروريا». فهنا تطول تقنية البعث لتطول حتى الظل الذي يصاحب الإنسان في حله وترحاله، ويتلبسه كضميره الذي يضمره، ولا يستطيع من سلطة فكاكاً…
11.سناء الشعلان: “الكابوس”، مرجع سابق، ص: 159.
12.سناء الشعلان: “قافلة العطش”، مرجع سابق، ص: 48.
13.سهير القلماوي: “ألف ليلة وليلة”، دار المعارف، القاهرة، 1959، ص: 173.
14.سناء الشعلان: “قافلة العطش”، مرجع سابق، ص: 100ـ 101.
سناء الشعلان: “الكابوس”، مرجع سابق، ص: 85.